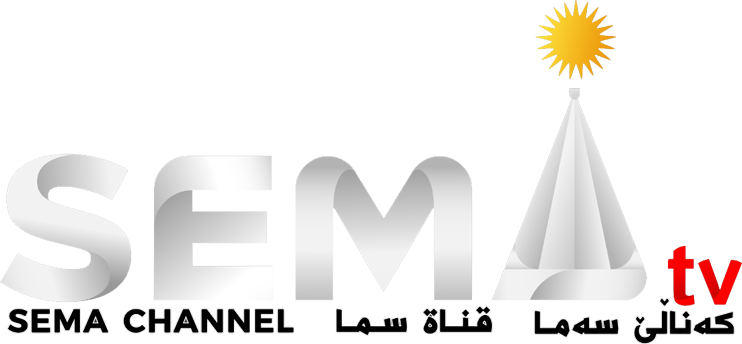دلشاد نعمان فرحان
تعيش اليوم الهوية الدينية للإيزيديين لحظةً مفصلية في تاريخها، لحظة لا تُقاس بطول الزمن، بل بعمق التحديات وتضادّ الخيارات، ففي زمن الشتات والانكشاف الحضاري، تُواجه هذه الهوية خطرين متناقضين في ظاهرهما، متماثلين في مآلاتهما: خطر الذوبان التدريجي في ثقافات الغير من جهة، وخطر الانغلاق المتصلب على الذات داخل قوقعة التاريخ من جهة أخرى، وكلا الخطرين لا يؤدي إلى النجاة، بل إلى التآكل البطيء للمضمون الروحي والثقافي الذي شكّل جوهر الشخصية الإيزيدية عبر قرون.
إن سؤال الهوية، كما يُطرح في السياق الإيزيدي، ليس سؤالاً عن ماضٍ منقرض أو عن ذاكرة فولكلورية تُستحضر عند الحاجة، بل هو سؤال وجودي قلق: كيف نحافظ على الذات دون أن نحاصرها؟ وكيف ننفتح على العصر دون أن نذوب فيه؟
هنا تتقاطع هذه الإشكالية مع ما عبّر عنه (فيودور دوستويفسكي) في أعماله الكبرى، لا سيما في رواية (الإخوة كارامازوف)، حينما رسم ملامح الصراع الداخلي بين الروح الأصيلة والضغوط الخارجية التي تسعى لقولبتها ففي رأيه “الإنسان إذا فقد الله، فقد نفسه”، وفي السياق الثقافي، يمكن القول: إن الجماعة إذا فقدت معناها الجوهري، فقدت مبرر وجودها.
الهوية الدينية الإيزيدية، إذن، ليست قناعاً اجتماعياً بل كينونة، متجذرة في تراث ديني غني ورؤية كونية خاصة، لكنها، في ظل المتغيرات الجيوسياسية ووسائط العولمة، مطالَبة بإعادة تعريف ذاتها، لا من خلال التنازل عن خصوصياتها، بل عبر تجديدها وتجسيدها في أطر جديدة، لأن الهوية التي لا تُترجم إلى فعل، تبقى محصورة في الذاكرة، أو ما يمكن تسميته بـ(النوستاليجا المعيقة).
وهنا، فالتحصين لا يعني العزلة، بل القدرة على التميّز وسط التفاعل، والتجديد لا يعني الانسلاخ، بل استعادة الروح القديمة بأدوات معاصرة، لأن خلق خطاب إيزيدي حديث، يُعبّر عن الذات دون أن ينكر الآخر، ويستثمر الإرث دون أن يُجمّده، هو ما يشكّل الترياق الحقيقي ضد كل من الذوبان والانغلاق.
وقد بيّن (دوستويفسكي) في أعماله، هشاشة الإنسان حين يُنتزع منه إيمانه أو قيمه، وهذا ينطبق على المجتمع أيضاً، فإذا ما أراد الأيزيديون البقاء فاعلين في زمن الحداثة، وما بعد الحداثة، لا بد أن يعيدوا هندسة هويتهم، لا عبر إعادة إنتاج الماضي حرفياً، بل من خلال بلورته إلى طاقة أخلاقية وجمالية قادرة على الإسهام في الحضارة المعاصرة.
ولذلك، فإن الهوية الدينية للإيزيديين مطالَبة اليوم بالانتقال من حالة (الذاكرة المحمية) إلى (الذاكرة المنتجة)، حيث يصبح الماضي ركيزة للمستقبل، لا عائقاً أمامه، فكما أن الرواية الكبرى لا تُكتب إلا بصدق داخلي وتحوّلات درامية، كذلك فالهوية لا تُصاغ إلا بإرادة نقد ذاتي ورؤية استباقية.
وفي المحصلة النهائية، فإن الهوية ليست وثناً يُعبد، بل مشروعاً مستمراً، يتجدد بقدر ما يُحصّن، ويتحصّن بقدر ما يُبدع.