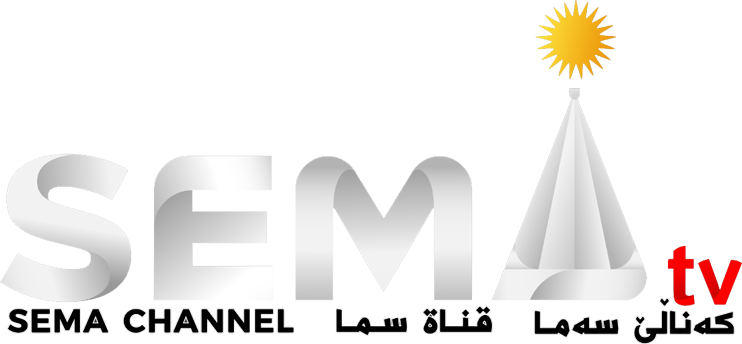أنطوان أبو زيد
ملخص
كتاب “فلسفة الرغبة”، واحد من أعمال الفيلسوف الفرنسي فريدريك لو نوار، وفيه يطلق أطروحة أساسية حول مفهوم الرغبة، كان السبّاق فيها، وبات الأكثر تمثيلاً لها، وهو المفهوم الأشد ربطاً بالتراث الفلسفي القديم وفلسفة الأنوار، وبآخر ما خلصت إليه علوم البيئة المعاصرة، وتنبيهاتها بخصوص الإفراط في الاستهلاك وإهلاك البيئة.
ينطلق الفيلسوف فريدريك لونوار في كتابه “فلسفة الرغبة” (ترجمة إسكندر حبش، دار الساقي) من مسلمة اقتبسها من الفيلسوف الألماني الشهير باروخ سبينوزا (1632-1677)، التي مفادها أن “الرغبة هي جوهر الإنسان” ليقيم أطروحته الفلسفية التي تعتبر أن الوجود الفاعل والنشط للكائن الحي، في القرن الـ21، هو رهن بتحقيق رغبته التي تعادل حفاظه على وجوده قيد الحياة.

وأول خطوة في سياق بسط هذه الأطروحة، تقوم على تبيان الفروق بين الرغبة باعتبارها “تطلعاً إلى الخير” بحسب فلاسفة العصور القديمة، والحاجة أو الغريزة التي تستدعي الإشباع من أجل بقاء المرء على قيد الحياة. ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الفيلسوف غاستون باشلار، بالقول إن “الإنسان من إبداع الرغبة، وليس من إبداع الحاجة” (ص:14) علماً أن الحاجة، وهي بخلاف الرغبة، من لزوميات حياة الكائن المادية التي جعلها الفيلسوف التربوي الأميركي أبراهام ماسلو (1908-1970) في أدنى هرمه المشهور، وفي أعلاه ما يتفق مع تعريف لونوار للرغبة، ونعني به تحقيق الذات بما ترغب فيها رغبة نابعة من إرادتها الحرة في فعل ما هو خير لها، وتقديرها حق قدرها، وتوفير الأمان العاطفي لها، بالحب والانتماء.
دواعي الرغبة المتسامية
ثم إن الكاتب يعمد، في القسم الأول من الكتاب، إلى ذكر الدواعي الفلسفية، وتلك الواقعية التي تقدم الرغبة على أنها الكلمة-المفتاح لأطروحته المقتبسة من صميم تراث فلسفة الأنوار، ومن هذا القبيل، لا يني الكاتب يستشهد بأقوال الفلاسفة الأوائل، من أفلاطون وأرسطو، مروراً بسبينوزا، ووصولاً إلى إيمانويل كانط، وشوبنهاور، تأكيداً على أولية الرغبة وطبيعتها السامية عند الإنسان المدرك لجوهره. فعلى سبيل المثال، يعد أفلاطون أن البشر مفطورون على الرغبة/ والنقص، بمعنى أنهم يلبثون، وبسبب طبيعتهم القائمة على النقصان- أي من دون الخلود – عاجزين عن تحقيق رغباتهم، في حين يعتبر إيمانويل كانط أن “السعادة هي حالة كائن منطقي في العالم، فما يحدث له، طوال فترة وجوده، يتأتى وفقاً لرغبته وإرادته” (ص:26) بيد أن الإرادة وحدها قد لا تكون عاملاً حاسماً في تحقق الرغبة والسعادة، ذلك وإن تكن الرغبة طوع الكائن، فإن كثيراً من العوائق الخارجية، والحالات النفسية الداخلية تحول دون تحققها، وفق ما يقول شوبنهاور: “تتأرجح حياتنا كلها مثل البندول من المعاناة إلى الملل…”
ومع ذلك فإن ثمة حقائق علمية، بحسب الكاتب، تدلل على مكانة الرغبة في حياة الكائن، إذ يعتبر العالم سيباستيان بوهلر الباحث في ما يربط الفنون التطبيقية بعلم الأعصاب أن القشرة الدماغية، عند الإنسان، هي ” السلاح الرئيس للإنسان، التي جعلته سيد كوكبنا” (ص:32) لأنها كفيلة بتوجيه رغباته، وتوفير المكافآت المجزية، بأن تنتج له مادة الدوبامين جلابة المتعة والرضا. وفي المقابل، فإن إكراه المرء على عمل أو أداء واجب بالقوة يكون مجلبة لشعور بالمرارة والضيق، يفضيان به إلى المرض الجسماني، لحرمانه من المحفزات الطبيعية الموجودة في تكوينه الفيزيائي، ونشوء منغصات جسمانية مضادة للأولى، ونافية للسعادة.
أما الفيلسوف وعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي رينيه جيرار، فيرى أن الإنسان مطبوع على محاكاة الآخرين، ويكشف عن ذلك إذ يحلل الشخصيات النموذجية في كل من الروايات الآتية: دون كيخوته، وإيما بوفاري، والأحمر والأسود، فيكتشف أن كلاً من شخصياتها تقلد نموذجاً كان لا يزال سائداً في زمنه، ويعطي أمثلة على ذلك شخصية دون كيشوت، الفارس المتجول الذي صوره ثيرفانتس على مثال الفرسان المتجولين في عصره، وكذلك فعل فلوبير في رسمه شخصية إيما بوفاري ورغباتها “على مثال الروايات العاطفية التي قرأتها في شبابها” (ص:42)، وكذا شخصية جوليان سوريل، في رواية ستاندال جعلت نموذجاً للمتكبر، والحاقد، والحاسد غيره، لا سيما إذا كان غريمه في حب إحداهن.
انحرافات الرغبة
لكن لونوار إذ يعيد الاعتبار للرغبة على أنها جوهر وجود الإنسان، ومنطلق صلب لبناء هويته ومعنى وجوده عبر تحقيق طموحاته وأهدافه السامية، فإنه ينبه، في أجزاء من الكتاب، من انحرافات الكائن عن مسعاه المثالي، بل المتوازن، السالف وصفه. ومن تلك الانحرافات ما أحدثته الثورة الصناعية، وما لازمها من نزعة استهلاكية مفرطة، ومستدامة، أفضت إلى خلق حاجات، وترسيخها في ذهن الإنسان المعاصر، وجعل الامتلاك أولية عنده، يبذل في سبيلها ماله وكرامته وراحته ومستقبله، وينسى تحقيق أنبل ما فيه، وخير ما فيه، عنيت رغبته الأولى والسامية. حتى ليستبدل بعضهم شعار “أنا أفكر، إذاً أنا موجود” للفيلسوف ديكارت، بشعار “أنا أستهلك، إذاً أنا موجود”.
وقد زيد إلى خطر الاستهلاك، أخطار أخرى تحول دون تحقيق الرغبة السالف وصفها، ومن تلك الأخطار إدمان المرء على الشبكات الاجتماعية، وانصرافه الكلي إلى حيازة الإقرار، من قبل المجتمع الافتراضي، بمكانته وإعادة اعتباره وسط بيئته، وجماعته، وذلك على حساب نمائه المهني والأخلاقي، وطموحاته البناءة. والقول نفسه ينطبق على أجيال من المراهقين، الذين ينغمسون في لجج الإنترنت، ويتيهون في صورها الغشاشة، فتحملهم على التغرب عن بيئاتهم، وتحدث تصدعات يصعب جسرها بين وعيهم ولا وعيهم الطريين، وبين الصور الخداعة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي وواقعهم المحدود، فيعمدون إلى الانتحار. ومن هؤلاء، يقول لونوار، “من ارتفعت نسبة دخولهم إلى المستشفيات عند الفتيات الصغيرات بسبب إيذاء الذات بين عامي 2009 و2015، إلى أكثر من 62 في المئة لمن هن بين 15 و19 عاماً، وأكثر من 189 في المئة للفتيات اللاتي بين 10 و14 عاماً” (ص:68).
وهنا، يحسن بالمعنيين، الراشدين منهم والمرشدين الاجتماعيين، أن يعملوا على معالجة إدمان هؤلاء المراهقين، بأن يدلوهم على السبيل إلى الاعتدال في استخدام الإنترنت، وتحفيزهم على تحقيق رغباتهم الحقيقية، والنابعة من توجهاتهم وميولهم الطبيعية، وهذه يدركها الأهلون الواعون والمحبون لأبنائهم والبنات.
الرغبة-الإبداع
قد يكون من العسير متابعة كل مفاصل الأطروحة التي انطوى عليها كتاب الفيلسوف الفرنسي لونوار. وفي المقابل، من المفيد الإشارة إلى بعض النقاط التي تشكل رؤيته البناءة البديلة عن منغصات الرغبة وانحرافاتها، ومن تلك النقاط، ما اقتبسه عن الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون (1859-1941) لا سيما نظريته في “التطور المبدع” التي أكد فيها، ومن خلال الملاحظات البيولوجية الدقيقة، “أن الحياة تتطور من تلقاء نفسها، بل هي تخترع نفسها باستمرار في إبداع زخم خلاق” (ص:147). بالتالي، يتعين على الكائن البشري أن يتغلب، بوعيه، على الغريزة في خطوة حاسمة من الدافع الإبداعي الكامن في نفسه، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم.
وفي هذا الشأن يدعو لونوار قارئه إلى الإبداع، في أي مجال يبرع فيه، سواء كان مفكراً، أو أديباً، أو رياضياً، أو طباخاً، أو مزارعاً، أو ممارساً أي مهنة، مهما تكن. ذلك أن الإبداع في العمل، بحسب الكاتب، يشعر المبدع بأنه على قيد الحياة، وأنه قادر حتماً على تجاوز غريزته، أو حاجاته المادية الأساسية. وعلى هذا النحو، قد يشعر الكائن المبدع، أو في طريق الإبداع، أنه عنصر فاعل في الطبيعة، ومرتبط بحركاتها، ومتواصل معها. وفي هذا قدر من السعادة أفقدنا إياه الجري اللامتناهي وراء طلب العيش، من دون عيش اللحظة، بحسب ما يدعونا إليه الكاتب، بسرده لنا بعض لحظات التأمل في أحضان حديقة المنزل أو زيارة الجدول الصغير الذي يحد المنزل، أو الاستلقاء فوق العشب “ناظراً إلى الغيوم” (ص:151).
العيش ببهاء
في القسم الثالث والأخير من كتاب “فلسفة الرغبة”، يودع الكاتب أغلى ما تمخضت عنه فلسفات القرن الـ19، وأوائل الـ20، في شأن أسلم السبل لعيش متوازن، وحيوي، ومتجاوز حدود الزمان والمكان، وأعني بها فلسفة سبينوزا، ونيتشه، وبرغسون، وأندره جيد، والداعية جميعها إلى تغليب الإرادة في العيش الفرح، وتذوق اللحظة، والتسامي على الغريزة، وطلب الصداقة القائمة على “الحب الخيري” (ص:168)، والمجانية، والحب العاطفي الخالي من الأنا، وروحانيات الرغبة، وتغليب تكوين الذات على امتلاك متاع الدنيا.
ويبقى على القارئ أن يستجلي رأيه، في ما عرضه الكاتب الفيلسوف، ويستخلص الممكن فيه من المحال. والأكيد أن النظر الفلسفي لازم في أزماتنا الوجودية، فكيف بأطروحة الرغبة.