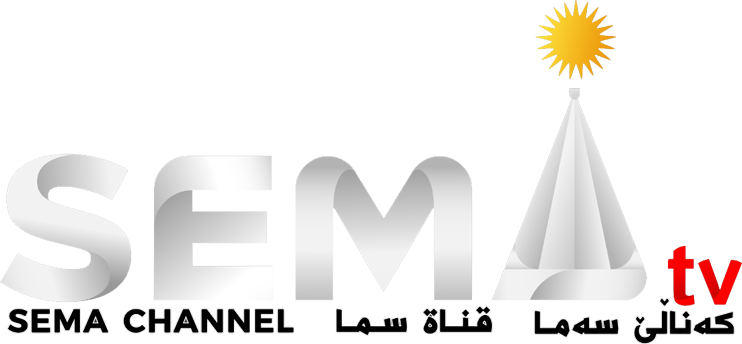نبيل سحنون
يرى هابرماس أن العلم ليس بريئًا وليس محايدًا وليس نزيهًا!
فالعلم في سياق العقلانية التقنية تتلبسه حسابات السياسة، أي إرادة قوة بالمعنى النيتشوي تنبغي تعريتها وإخراجها إلى واضحة النهار، الأمر الذي يستلزم نقد المذاهب الوضعية والنزعة العلمية المتطرفة (Scientism) والنزعة التقنية، بوصفها جميعًا تعبيراتٍ عن الأيديولوجيا المكونة للحداثة التقنية، أما الوضعية فهي تميل إلى تحنيط العلم حتى ليتحول إلى دينٍ جديدٍ دوجماوي يقدم أجوبةً وثوقيةً عن كل الأسئلة الممكنة ويقدم حلولًا ناجعةً لكل المشكلات، وأما النزعة التقنية فهي الميل إلى اعتبار التطبيق العملي للمعرفة العلمية هو وحده الكفيل بتقدم المجتمع، واعتباره توظيفًا عمليًّا محايدًا للمعرفة العلمية، متناسية أن التقنية تحول البشر أنفسهم إلى وسائل وأدوات، فتقمع طاقاتهم الإبداعية والتحررية، وبهذا المعنى فهي أيديولوجيا تلعب دورًا أساسيًّا في إضفاء المشروعية على النظام الاجتماعي والسياسي الحديث القائم على العقلانية التقنية.
ويعود الفضل إلى ماكس فيبر في استخدام مفهوم «المعقولية» لوصف الشكل الرأسمالي للنشاط الاقتصادي، والنمط البرجوازي للمبادلات والأنماط البيروقراطية للسيطرة؛ وعليه فإن العقلنة تعني توسيع المجالات المجتمعية التي تخضع لمعايير القرار العقلي، والتي تسير بموازاة تصنيع العمل الاجتماعي وميكنة الحياة الاجتماعية وإضفاء الصفة الآلية والتقنية على حياة الإنسان، إن ما يميز الحضارة الصناعية المتقدمة هو رزوحها تحت أشكال من الرقابة المتعددة المستويات، تُحشر في عداد العقلنة والتخطيط والترشيد المتوخية كلها تحقيق «غايات» و«أهدافٍ» معقلنة.
ويؤكد هابرماس أن «العقلنة» المتزايدة للمجتمع تتم بموازاة عملية إضفاء صيغة المؤسسة على التقدم العلمي والتقني، فبقدر ما يتدخل العلم والتقنية في مؤسسات المجتمع ويُفقدانها طابعها كمؤسسات، تغدو الإنتاجية هي المعبئ الوحيد للمجتمع وتضع نفسها فوق كل مصلحة.
هكذا يحول هابرماس مفهوم العقلنة، مثلما استخدمه ماكس فيبر، ويكيفه تكييفًا يجعله يسير على قدميه، وليس على رأسه كما كان الأمر مع هذا الأخير، وهابرماس، هنا، يقتفي أثر ماركوز الذي انتقد الطابع الصوري للمعقولية في صيغتها الفيبرية، وكأنها مجرد عمليةٍ تتم في حدود نشاط عقلي يقرره رئيس مؤسسةٍ رأسمالية متوخيًا منه تحقيق غايات وأغراض عملية استنادًا إلى معايير العلم والتقنية، فهو يرى أن خلف هذه «المعقولية» المظهرية ثمة إرادة سياسية ثاوية تسعى إلى توسيع مجال السيطرة وعقلنته، فكل عقلانية تكنولوجي يحايثها (يباطنها ويحل بها) منطقٌ للسيطرة يتمثل في إخضاع الإنسان لنظام الأشياء، فما دامت معقوليةٌ من هذا القبيل تقوم على وضع الخطط والاختيار بينها بحثًا عن أفضلها، واستخدام التكنولوجيا الملائمة وتهيئة الأنظمة المناسبة والمواتية لبلوغ غاياتٍ ثابتة ومحددة، فإنها تبقي شيئًا يتم في غفلةٍ عن التفكير، وفي خلسةٍ من المصالح الاجتماعية الكبرى، معقولية من هذا القبيل لن تخدم سوى علاقات التسيير والتحكم التقني، إنها تفترض نوعًا من السيطرة على الطبيعة أو على المجتمع، ذلك أن النشاط العقلي حينما يضع لنفسه غايات، يتحول إلى رقابة؛ لذا فإن «عقلنة» شروط الحياة تعني في نهاية الأمر تحويل السيطرة إلى مؤسسةٍ لها شرعيتها، والتي لا ينتبه إلى أنها شرعية سياسية، وهذا هو جوهر النقد الذي يوجهه ماركوز ثم هابرماس إلى ماكس فيبر.
ففي المجتمعات الرأسمالية المتقدمة صناعيًّا تتجه السيطرة إلى أن تفقد طابعها القمعي المعيمن والمسيطر لتتحول إلى نوعٍ من السيطرة «المعقلنة»، من دون أن تتخلى مع ذلك عن طابعها.
غير أن الطابع القمعي لا يختفي تمامًا، بل يتخذ لنفسه مظاهر وتجلياتٍ تتمثل في خضوع الأفراد ورُزُوحِهم تحت نير جهاز الإنتاج والتوزيع واندماجهم الكلي في منطقه، إلا أن الأفراد لا يعون الجوهر القمعي لكل ذلك؛ لأنه يُضفي على نفسه رداءً جديدًا من الشرعية، مفاده الزعم بأن السيطرة على الطبيعة والتحكم في الإنتاجية المتزايدة هو ما سوف يضمن للأفراد شروط العيش الرغيد.
لقد فاق تعاظم قوى الإنتاج، والذي هو إحدى مميزات التقدم العلمي والتقني المعاصر، كل النسب والحدود، ومبادئ العلم الحديث قد رُكبت وبُنيت، مسبقًا، على نحوٍ يمكن معه استخدامها كأدواتٍ مفاهيمية من طرف عالم الرقابة الإنتاجي الذي يجدد نفسه بصفةٍ أوتوماتيكية، وكان من نتيجة ذلك أن اندمجت النزعة الإجرائية النظرية بالنزعة الإجرائية العملية وامتزجت بها، وهكذا قدم المنهج العلمي، الذي فتح الباب على مصراعيه أمام السيطرة الفعالة على الطبيعة، مفاهيم بحتة، ولكنه قدم أيضًا مجموع الأدوات التي سهلت سيطرة الإنسان على الإنسان على نحو مطرد الفاعلية من خلال السيطرة على الطبيعة، ولقد أصبح العقل النظري، بمحافظته على بقائه وحياده، خادمًا للعقل العملي، ولقد كان هذا التلاقي مفيدًا لكليهما، واليوم لا تزال السيطرة قائمة، وقد أخذت طابعًا أكثر شمولًا بفضل التكنولوجيا، وبوجهٍ خاص بوصفها تكنولوجيا، فالتكنولوجيا تبرر ابتلاع السلطة السياسية من خلال امتدادها إلى كل دوائر الثقافة.
في كتابه «المعرفة والمصلحة» الذي صدر عام ١٩٦٨م (أي في نفس العام الذي صدر فيه «التقنية والعلم كأيدلوجيا») رسم هابرماس الخطوط العريضة لتأويليته النقدية، وذلك عندما قسَّم المصلحة البشرية إلى ثلاثة أقسام: المصلحة التقنية أو الأداتية، والمصلحة العملية، والمصلحة التحررية.
“أما المصلحة التقنية” أو الأداتية فهي تلك التي تحكم العلوم التجريبية، وتستخدم المناهج الإمبيريقية-التحليلية للوضعية لكي تستخلص المعرفة الأداتية للعلوم الطبيعية، إن ما يميز عبارات العلوم التجريبية هو أن دلالتها تكمن في قابليتها للاستغلال التقني، وهذا هو سر الارتباط بين المعرفة التجريبية والمصلحة التقنية.