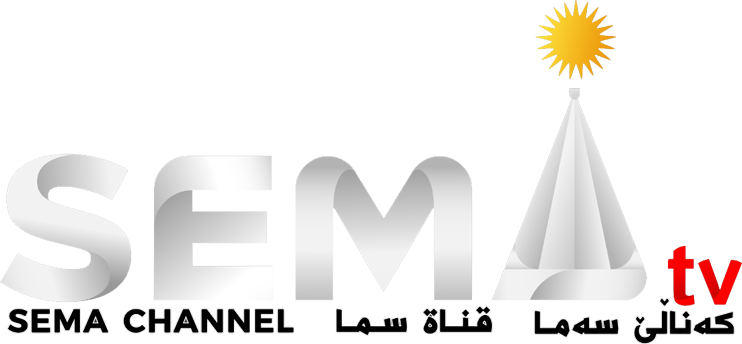من كتاب آل حربا حكاية عائلة فنية توطئة
مراد سليمان علو
(1)
ما أن بدأت بالكتابة عن (العمّ علي حربا)، حتى أختار قلمي الدخول في عالم السريالية، وبدأت بزخرفة الجمل دون وعي، وصبغت الكلمات بألوان القرية التي عشت فيها جنبا إلى جنب مع هذه العائلة المبدعة. وكأنني كنت فردا منها، وكأنهم كانوا أفرادا من عائلتي؛ وهذا ما تعلمّنا القرية: “الحبّ”. أن نحبّ بعضنا كأخوة. ونعيش معا كعائلة.
فأيّ محظوظ كنت؟
من السهل التكلم عن بداية الحكاية ـ أية حكاية ـ بل من الممتع إعادة سرد تلك التفاصيل التي تشبه الفراشات البرتقالية وقد عادت للتوّ من الهجر، وهي تحمل على أجنحتها نقوش شنكالية، بكل ما يحمله حوض جبل شنكال من تاريخ مزدان بالجمال والإنسانية. ولكن من الصعب جدا، بل لا يمكن أبدا تحديد: كيف؟ ولماذا انتهت تلك الحكاية؟
كل ما أعرفه. وأنا هنا، أتكئ على الذاكرة. فهذه عائلة فنيّة ومبدعة في مجالات شتى، امتهن أفرادها وتوارثوا الفن كهواية والنبوغ كان موجودا وما يزال في جيناتهم. وهم ليسوا محترفين أو مشهورين، ربمّا حتى الماضي القريب. ولا توجد ـ على حد علمي ـ كتب أو مقالات فنية في الجرائد والمجلات المتخصصة عنهم، وعن تجاربهم في الفن؛ لذلك فضّلت أن يكون محتوى هذا الكتاب مشابها لأسلوب حياتهم. وأن يكون مزيجا من الفرح والدهشة، وفتح ألبومات صور نادرة مختبئة في ثنايا الذاكرة.
ولم تكن هذه الصور والذكريات ستخرج وترى النور؛ لو لا تكليفي من قبل زملائي في (مركز الشمس للدراسات والبحوث) في ألمانيا؛ للكتابة عن شنكال وقراها، في مجال الأدب، أو الفن. وطبعا زملائي يتأملون دراسة كلاسيكية أتبع فيها خطوات البحث العلمي. وفق منهج معين. لكنني وجدت نفسي أسرد حكاية تشبه تلك التي كان يحكيها لنا (العمّ علي حربا) عندما كنا صغارا نتجمّع في ليالي شتاء القرية حول نار الحطب.
كل ما أتذكره، إنه مع كلّ رحيل كان الأمر يزداد سوءا. الرحيل الإجباري من القرى سنة (1975). والنزوح سنة (2014). ثم، التهجير إلى المنافي البعيدة. وأخيرا الرحيل الأبدي للأجساد، وعودة الأرواح إلى منابعها لتتكرر الحكاية، وكأننا في المسلسل الألماني الشهير(DARK) وفق رؤية نيتشوية.
وفي النهاية، ورغم كلّ شيء. رغم الأسى الذي نعيشه، والحزن الساكن فينا؛ نحن لا نمانع أن نعبر المسافات الطويلة ونجتاز القارات والمحيطات؛ فقط؛ لنرى أحبابنا في الأعياد. وعندما نخرج معا لنزهة مسائية؛ نحييّ الأشجار، ونميل بنظرنا صوب السواقي؛ لنتأكد من جريانها بمرح، ووجود ضفادع خضراء بالقرب وهي تقفز، ونبتهج بزقزقة العصافير، وأناشيد الطيور؛ وما أن نبتسم حتى نرى الشمس وهي تضحك لنا، فنتأكد بأن الأيزيدياتي ما يزال يقبع في أعماقنا.
ومع تعدد الرحلات وطولها الذي يساوي سنوات العمر، نتذكر باننا لم نؤذ أحدا ولم نسيء لشخص بل نحن الذين غدر بنا، فنبكي مع كل رحيل. نبكي في المخيمات، نبكي في المهجر. نبكي في نهاية الأسبوع، وعندما نشاهد فيلما عاطفيا، أو نسمع مواويل شنكالية.
لكن، ماذا لو كانت المعجزة التي كنت تتمناها في طفولتك، تحدث لك دون أن تنتبه لها. ماذا لو كانت تلك المعجزة مستمرة كلّ هذا الوقت. والحكاية لم تنتهي، وماتزال تروى! وما عليك إلا أن تلتفت لتراها كغابة غطت الأفق بأغصان أشجارها وأوراقها الخضراء. حينها ستملأ رئتيك بالهواء، وتطلق زفيرا حارا، وستفرح بتواجد من تحبهم قربك، وفي معظم بلدان العالم. يتسابقون ليلتحقوا بالمدنية في كلّ مكان، حالهم حال أرقى الشعوب، بل تراهم يزاحمون المبدعين في كل مجال.